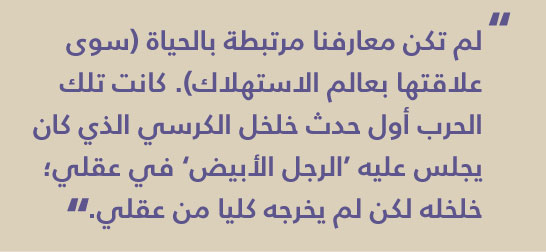خليل السكاكيني
نسمع كثيرا هذه الأيام عن روعة التعليم بفنلندا. نسمع كيف تركّز فنلندا على تطوير نظام التعليم فيها حيث أصبحت أقوى دولة في التعليم عالميا وفق تقارير التنافسية العالمية. يُعتَبَر التعليم مكوّنا أساسيا للثقافة الفنلندية وبَنَتْ هويتها حوله. كذلك نسمع كيف يتم بعناية شديدة انتقاء معلمين ذوي كفاءة عالية (على الأقل ماجستير ومن الأوائل في الجامعات). يعمل المعلمون ساعات أقل وراحة أكثر. هناك تركيز على العمق بالمضمون بدلا فقط من زيادة المضمون والتعامل معه بسطحية. الساعات التي يقضونها يوميا بالصفوف أربعة، والباقي خارجها. لا يوجد فصل بين الطلاب على أساس مستواهم التعليمي مما يعني العمل على رفع المستوى التعليمي لدى الأطفال الذين يحتاجون إلى عناية أكثر ليصلوا إلى المستوى السائد بين زملائهم، وهو ما جعل فنلندا تمتلك عالميا (وفق دراسات مهتمة بالتعليم) أصغر فجوة بين الطلاب الأقوى والأضعف في مستوياتهم التعليمية. الارتباط بين المعلم والطالب قوي وطويل مما يوطد العلاقة بينهم. يبلغ عدد الطلبة 20 في الفصل الواحد. تُعْطى المساواة بين الطلاب أهمية قصوى في التعليم. هذا يجعل الطلبة هناك سواء أكانوا في مناطق ريفية أم مدينية، فقيرة أم غنية، يحصلون على جودة تعليم متساوية ويتم توزيع المال بالتساوي للمدارس. لا توجد تصنيفات ومنافسة بين المدارس؛ جميعها يعمل وفقا لأهداف قومية واحدة. باختصار، يحصل التعليم في فنلندا على أعلى التقديرات بين الأنظمة التعليمية بالعالم. عامل أساسي في هذا يعود لمعارضتهم للنموذج القائم على تقييم مركزي. نادرا ما تُجرى امتحانات أو تُعطى فروض بيتية (إلا بعمر أكبر). لا يوجد قياس خلال السنوات الستة الأولى. يوجد امتحان بعمر 16 سنة. 66% يذهبون إلى الجامعات (أعلى نسبة بأوروبا). المنهاج يتكون من إرشادات عامة…
* * *
ملاحظات سريعة:
أود قبل أن أبدي ملاحظاتي أن أذكر باختصار ما أراه يلخص ما سأقوله: رؤية التعليم بفنلندا تنتمي إلى الأغصان، بينما رؤية السكاكيني تنتمي إلى الجذور. [أستعير هنا قولا لجلال الدين الرومي: ‘ربما تبحث بين الأغصان عما يظهر فقط في الجذور’، والذي أجده قولا رائعا يوضّح لنا إذا كان انتباهُنا فيما نقوله ونفكر به ونفعله ينتمي إلى الأغصان أم إلى الجذور.]
الملاحظة الأولى: لاحظ السكاكيني (قبل فنلندا بأكثر من قرن) أن المشكلة الجوهرية في التعليم تكمن بوجود تقييم عمودي وأنشأ مدرسة بالقدس (1909) شعارها ‘إعزاز التلميذ لا إذلاله’ وترجمه ب‘لا علامات ولا جوائز ولا عقاب’. أنشأها بناءً على ما خبره في التعليم الذي جلبته جاليات أوروبية وأمريكية. لم يسْعَ أن تكون مدرسته نسخة عنه أو أفضل منه. فذلك التعليم لم يكن مرجعيته، وفكرة المنافسة كانت غائبة من فكره. كان همُّه خلق جوّ مليء بالحيوية والصدق والمحبة والكرامة. قناعة أخرى لديه هي تعرُّف الطلبة على فلسطين مشيا على الأقدام. كان نهجه البناء على مقومات متوفرة بما في ذلك التعلّم كقدرة بيولوجية. تأثّر بما قرأه بكتب عربية قديمة ملؤُها الحكمة. أفقه التربوي (خاصة قبل الاحتلال الانكليزي الفرنسي للمنطقة عام 1917) كان أفقا حضاريا. الحكمة والأفق الحضاري وقراءة الواقع هم ما ميّز السكاكيني، وهم ما أجد مفقودا من التعليم الفنلندي. ما قلّص ذلك الأفق لديه هو الاحتلال الانكليزي الفرنسي الذي قسّم بلاد الشام إلى 4 دويلات. فكرة الدولة ومكوناتها (خاصة التعليم الرسمي المركزي) كانت بمثابة أمراض فكرية إدراكية اجتماعية جلبوها معهم. جدير بالذكر أن السكاكيني حذّرنا من التعليم الرسمي قبل الاحتلال العسكري ب 20 سنة، إذ اعتبره إذلالا واحتذاءً بحذاء الغير؛ انتبه إلى ذلك بعقله الفطري وأمانته الفكرية.
الملاحظة الثانية: رفَضَ السكاكيني التقييم العمودي المركزي من منطلق كرامة الإنسان التي ترتبط باحترام التنوع في الحياة. ترفض فنلندا، في المقابل، التقييم من منطلق المساواة، مفهوم ذهني له إيحاءات إيجابية لكن عادة بمضمون سطحي إذ يتضمن عادة عدم احترام التنوع. المساواة ترتبط بالأغصان، الكرامة بالجذور؛ المساواة مفهوم ذهني، الكرامة سلوك اجتماعي. اللبنة البنائية الأساسية في مجتمعات الأهالي هي المجاورة التي تشكل رَحِم المجتمع إذ تحميه مما يمكن أن يضره. تأكيد فنلندا على أهمية أن يصل كل الطلبة نفس المستوى، لا يتوافق مع التنوع، وينطبق ليس فقط على المعارف بل أيضا على المأكولات التي تُقَدَّم للطلبة لضمان أن يحصل جميعُهم على مأكولات تُغذّيهم. عملٌ لا شك جميل، لكنه يهمل التنوع في التذوق (حاسة هامة بالإنسان) كما يهمل التنوع فيما تحتاجه الأجسام. فكما أن العقول تختلف بالنسبة لما تحتاجه بالنسبة لعافيتها الذهنية ولإرواء عشقها للمعرفة والفهم، كذلك الأجسام تختلف بالنسبة لما تحتاجه لعافيتها وعشقها للمأكولات. الكرامة تشمل احترام تنوع الناس بالنسبة للفكر والمأكولات وطرق العيش. فرقٌ رئيسي بين المساواة والكرامة أن المساواة تتطلب قوانين ومهنيين ومؤسسات ومقاييس، بينما الكرامة تتطلب حُكْمَ الذات؛ مسؤولية الشخص في أن يكون شريكا في تقرير ما يدخل عقله وجسمه وأيضا قلبه وروحه. بتركيزه على الكرامة، السكاكيني قريبٌ من قولٍ هنديٍّ قديم: ‘كل إنسان كامل بشكل فريد’. كل إنسان فريد وليس فردا: هو مصدر فريد للمعنى والفهم؛ ومكوّنٌ من علاقات. باختصار، اختلافٌ جوهري بين السكاكيني وفنلندا يكمن في الإدراك والوسيط.
الملاحظة الثالثة: السكاكيني بنى مدرسته بدون دعم حكومي أو خارجي وبدون أن تكون له أي علاقة مع جاليات أو مؤسسات أجنبية، وبدون الاستعانة بخبراء يُسْقِطون على الناس حلولا جاهزة ‘من فوق’ ويستعملون كلمات لا تستمد معانيها من الحياة بل من سلطة وخبراء وظيفتهم الرئيسية إقناع الناس بأن الماضي متخلف وولى زمانه.
الملاحظة الرابعة: لو وُلد السكاكيني بفنلندا، لرفضت السلطات هناك توظيفَهُ كمعلم، ولَمَنَعَتْهُ من إنشاء مدرسة لأنه لا يحمل شهادة ماجستير ولم يكن من الأوائل في الجامعة، بل لم يدخل جامعة أصلا! كم أنا سعيد أنه وُلِدَ بفلسطين وليس بفنلندا وأنه لم يسلك طريق الجامعات؛ إذ لو وُلِد بفنلندا وسلك طريق الجامعات لخسرناه كمُلْهِمٍ لنا – على الأقل عربيا – إذ لَمَا سُمِحَ له أن يسهم في إدراكنا للتعلم بأنه قدرة بيولوجية وأن نرى جوهر التعليم بالوضوح الذي رآه (كإذلال واحتذاء بحذاء الغير)، ولَمَا تجرّأ على إنشاء مدرسة بالرؤيا المدهشة التي أنشأ وفقها مدرسته عام 1909، ولَمَا سمعنا من أحد أن أهم ناحية في حياة شخص هي الكرامة (ليس التفوق والتميز). النظر إلى المرء عبر رموز كشهادات وتصنيفات يتناقض مع الكرامة والتنوع. المعلم الناتج عن خطة ومقاييس هو معلم ‘مهني’ يمرّ وفق مسار محدد حيث يحصل على شهادة رسمية ورخصة. ما أراه مغيبا من التعليم في فنلندا هو الكرامة والحكمة واحترام العقل الفطري.
الملاحظة الخامسة: تمثلت الكرامة في فكر وعمل السكاكيني (إلى جانب ما ذكرته بأعلاه) باعتبار اللغة العربية أساسا للمعلم في المجتمعات العربية. اللغة العربية كنز حضاري هائل وأداة رائعة لجدْل نسيج فكري بياني اجتماعي روحي في المجتمع، ومع التاريخ والحضارة والفنون والحكمة. فإذا لوّثنا ‘بوتقة’ الفكر هذه (كما يفعل التعليم الرسمي المبني على قيمتَيْ السيطرة والفوز) يتحوّل المدرّس إلى أداة مخدَّرة تعيد كالببغاء ما في الكتب المقررة. كان السكاكيني مقتنعا بأن اللغة العربية يجب أن لا تُدَرَّس عبر قواعد ونَحُو وصرف بل عبر منطقها الداخلي وعبر الغنى في معانيها والجمالية في بيانها والحكمة في ثناياها، والذي يتمّ عبر معايشتها وعبر تفاعلاتٍ تعتمد بالأساس على نُطْقٍ وإصغاء متبادل، وعبر أدب وشعر وحكايات. اللغة العربية منطقية بمعنى جذر أي كلمة هو فِعْل والذي منه يستطيع الطفل تكوين كلمات عديدة. يستطيع مثلا، بالفطرة، أن يشتق من ‘كَتَبَ’ كلمات مثل كاتب ومكتبة وكتاب ومكتوب ومكتب (ونَشَرَ عام 1943 كتيبا بهذا الخصوص). عشِقَ السكاكيني اللغة وسعى أن يعيش الطفل روحها ومزاياها، ليس بشكل آلي بل عن طريق أن تصبح جزءا من نمط تفكيره وبيانه وأسلوب حياته. من أجمل ما يميز العربية وجود المثنى (إلى جانب المفرد والجمع) وهو أمر مفقود في اللغات الأوروبية. المثنى علاقة تختلف جذريا عن ‘العلاقة مع الآخر’. من أسوأ ما خلّفته المستوطنات المعرفية الغربية (مدارس وجامعات) هو تشويه هذا الكنز. الخلل الأعمق في التعليم الرسمي هو ليس التلقين بل استبدال لغات حية بلغة رسمية لا تستمد معانيها من الحياة. تفاعُل الناس عبر لغاتٍ تستمد معانيها من الحياة يشكل خطرا كبيرا على من يريد السيطرة على الناس. من أخطر ما فعله الاحتلال المعرفي هو ليس استبدال لغة عربية بلغات أجنبية بل استبدال لغة حية بلغة حروفها عربية لكن مرجعيتها ومعانيها مستمدة من مصادر غربية. كلمتا ناجح وفاشل مثلا حروفهما عربية لكن معناهما يعودان إلى القبيلة الأورو-أمريكية. خبراء التربية والتنمية والحداثة والتقدم والعلوم والتكنولوجيا يغيّبون اللغة العربية ككنز حضاري فكري اجتماعي روحي ويحوّلونها إلى مادة دراسية! رغم إعجاب السكاكيني بالمتنبي وغيره، إلا أنه عندما بدأ بتوليف كتاب ‘الجديد في القراءة العربية’ (1924)، قرر أن يستعمل لغة أقرب إلى الحياة التي يعيشها الأطفال، حيث معانيها ودلالاتها مرتبطة ونابعة من حياتهم وخبراتهم، بحيث يحسّ بها الطفل ويعيشها، لا أن يتقنها آليا حيث تصبح سلعة كما يحصل عبر لغة الكتب المقررة: لغة اصطناعية تركيبية زائفة. همُّهُ أن لا تفقد اللغة العربية حيويتها وارتباطها بالحياة. تسليع الحياة (تحويلها إلى بضائع وخدمات) بدأ باللغة، وعبرها تحوّل الإنسان إلى مخلوق جلّ همّه المطالبة بسلع وخدمات! سؤال مغيَّب من التعليم الرسمي: كيف نفسر أن الأطفال يتعلموا ويتقنوا اللغة العربية قبل دخولهم المدرسة ثم يرسبون فيها كمادة مدرسية؟!
الملاحظة السادسة: الشرط بأن يكون المدرس حاصلا على ماجستير ومن الأوائل بين خريجي الجامعات يتناقض مع التأكيد بأن إحدى أهم ميزات التعليم الفنلندي هي معارضته للنموذج القائم على تقييم، إذ نجد أن معظم المؤشرات التي تُذْكَر لتميّز التعليم في فنلندا تعتمد على مستوى يُقَرَّر محليا ومقاييس وتقييمات دولية! هناك كما يظهر مستوى منشود على الطلبة والمدرّسين أن يصلوه. بالمقابل، عاش السكاكيني بعيدا عن العبودية لمقاييس على شتى الأصعدة؛ لا يوجد شيء واحد في فكره وعمله استند إلى مقياس، لا محلي ولا عالمي. جوهر ما ركّز عليه هو قِيَم وقناعات كالكرامة، لا عن طريق أن يصل إلى مستوى معين بل عدم الاحتذاء بحذاء الغير. تمثلت الكرامة في فكره وعمله بعدم استعماله أي كلمة تعكس فكرا أو معيارا عالميا. الكرامة تتناقض مع سعي الشخص كونه نسخة عن آخرين أو نموذجا يحتذي به آخرون (إذ ينزلق عندها نحو الاستهلاك ويصبح هو والمعرفة سلعا). فنلندا تعارض تقييم الطلبة لكنها لا تعارض، بل تفتخر، بتقييم التعليم فيها وفق مقاييس دولية! عارض السكاكيني فكرة التراتبية برمتها؛ لم يمارسها على الطلبة ولم يسْعَ لبرهنة أن مدرسته أفضل من غيرها.
* * *
كيف نفسر أن شابا من فلسطين بعمر 18 سنة قبل 120 سنة (دون الذهاب إلى جامعة وقراءة كتب تربوية) فكّر وعمل في مجال التعليم على صعيد الجذور، مما ساعده على تجنب كثير من أمراض الأيديولوجية المهيمنة؟ تفسير ذلك في رأيي أنه لم يتبع نموذجا جاهزا بل انطلق من انتباه شديد للواقع وحدّد القيم التي لا يناقضها في أفعاله. نعم، يحصل التعليم الفنلندي على أعلى التقديرات بين أنظمة التعليم في العالم لكن السكاكيني سلك طريقا لا ليبرهن أنه أفضل من غيره بل ليكون صادقا مع نفسه ومع الأطفال ومع واقعه وحضارته. ما رآه في الجذور خفيٌّ عن الأنظمة التعليمية الرسمية وحملة الشهادات العالية. ارتباطه بالجذور هو ما حماه من الانزلاق وراء ما هو مبهر في الأغصان. اللغة العربية في الكتب المقررة تنتمي إلى الأغصان؛ اللغة العربية الحيّة تنتمي إلى الجذور. لم يستعمل كلمات ممزِّقة ومحقِّرة كنجاح وفشل وتقدم وذكاء وقياس وتميُّز وتفوّق، مما ساعده في أن يتحكّم في اختيار كلماته ومعانيه. اختيار العرب قبل أكثر من ألف سنة اسم ‘بيت الحكمة’ لأول جامعة بنوها ببغداد (والتي تختلف جذريا عن تعبير ‘تعليم عالي’) ينطوي على روح ضيافة على صعيد الفكر والتعبير والمعنى والفهم، روح تتناقض مع الفوقية والشعور بأفضلية. تشكل الضيافة أحد أعمدة الحضارة العربية، وتمثّلت تاريخيا باستقبال غريب في بيتك دون أن تسأله من أنت ومن أين جئت وماذا تريد، مدة 3 أيام، وتمثلت في ‘بيت الحكمة’ باستقبال أفكار ‘غريبة’ من شتى الحضارات. شكّلت هذه الأمور جذور فكر السكاكيني في التعامل مع التعلُّم من منظور مغاير لفنلندا التي وجودها بأوروبا ربما أفقدها علاقتها بجذورها. ‘بيت الحكمة’ كان مكانا يدخله من يأتي إلى بغداد طلبا لتعميق فهمه ومعرفته وصقل فكره وبيانه؛ ‘بيتٌ’ مليء بمصادر مخطوطة وبشرية ولم يدّع أن لديه أجوبة جاهزة لتغيير العالم كما تفعل جامعات ‘النخبة’. يوجد مثلا في كلية التربية بجامعة ‘هارفارد’ برنامج learning to change the world . التركيز في ‘بيت الحكمة’ كان على تغيير الذات وصقل المعنى والعيش بحكمة. صديقٌ بكلية التربية طُلِبَ منه الذهاب ضمن لجنة إلى مصر لتحسين التعليم فيها. سألتُه: هل زرت مصر؟ قال: كلا. قلت: لا تعرف مصر لكن تعرف ما يناسبها؟! الاعتقاد بوجود نموذج عالمي يصلح لكل المجتمعات هو مرض فكري خبيث لعله الأخطر إذ يحتمي بكلمتين خبيثتين: خدمة (من فوق) وتنمية! كلمة ‘خبيث’ تصف التعليم الرسمي بدقّة: يُظْهِر شيئا بأنه حسن لكنه في العمق مُؤْذٍ بالتصميم. ربما يشكل التغلب على ادعاءات عالمية من أكثر التحديات التي نواجهها حاليا فهي أنجع قاتل للتعددية. بالنسبة لِمَنْ يؤمنون بأن طريق التقدم هو الاحتذاء بحذاء الغير، آمل أن يعيدوا النظر وينطلقوا من مقومات ذاتية كأساس ومرجع (بعد ذلك، يمكن أن يضيفوا أي شيء يشعرون أنه يعمّق ويوسع إدراكهم وفهمهم). المناعة الذاتية أغلى ما يملكه الإنسان والمجتمع لحمايتهما مما يمكن أن يضر بهما. هذه مسؤولية الناس على الصعيد الشخصي والجمعي. هذه المناعة على الصعيد الفكري ترتبط باعتبار ‘واجبي أن أتعلم’ أهم من ‘واجبي أن أدرس’، فالتعلم في رأيي هو أهم صفة في المعلم الجيد. في الوضع السائد، مسموح للمعلم أن يتعلم فقط عبر ورش عمل وبرامج تدريب يُعْطَى فيها معلومات ومهارات جاهزة؛ واجب الدراسة يلهينا عن التعلّم. فرق هام جدا بين السكاكيني والتعليم الفنلندي يكمن في أن السكاكيني لم يدرس، لا في جامعات ولا في ورش عمل ولا عبر مساقات وكتب مقررة وتقييمات، بل قضى حياته يتعلم.
تعامُل السكاكيني مع الجاسوس اليهودي يعكس بعدا آخر في حضارته: إجارة المستجير. بنهاية الحرب العالمية الأولى (1917) قرع باب السكاكيني شخص يهودي كان ملاحقا من قبل الجنود الأتراك بتهمة جاسوس. كان هناك قانون يحتّم على كل جاسوس أن يسلّم نفسه للسلطات. قرع ذلك الجاسوس أبواب يهود قبل السكاكيني، لم يقبله أحد. عندما قرع باب السكاكيني تساءل: أرفض خوفا من العواقب أم أفعل ما تمليه عليّ حضارتي العربية وأجير المستجير مهما كانت العواقب؟ تغلبت حضارته على خوفه. كانت امرأة يهودية تُحْضِر الأكل (كوشر) يوميا وتضعه على شباك غرفته دون علم السكاكيني. لاحظ بعض الجنود ذلك فقرعوا الباب وعثروا على الجاسوس؛ قادوه هو والسكاكيني مقيدين بالأغلال إلى سجن دمشق. كاد أن يخسر حياته لولا انتهاء الحرب وخروج السجناء – قصة السامري الصالح تعاد حرفيا بشكل مدهش؛ في هذه الحالة السامري هو الفلسطيني! تشير هذه القصة إلى ناحية أخرى في حياة السكاكيني تتناقض مع الأيديولوجية السائدة: الفرق بين المواطن الصالح والإنسان الصالح. ‘مواطن’ كلمة ترتبط بدولة حديثة حيث كل شخص يختلف عن الآخر برقم وطني. الجندي الإسرائيلي الذي يرفض الذهاب إلى الضفة الغربية ليهدم ويقتل ويعتقل يُعْتَبَر مواطنا غير صالح في إسرائيل ويعاقَب، لكنه بدون شك إنسان صالح بمعنى يحكم فِعْلَهُ.
مثال آخر ينتمي إلى الجذور وينبع من أفقنا الحضاري هو عبارة الإمام علي (التي تمثّل أروع ما قرأت في التربية): ‘قيمة كل امرئ ما يحسنه’ بشتى معاني يحسن بالعربية (الإتقان والجمال والنفع والعطاء والاحترام). تشكل العبارة مصدرا لقيمة المرء يجسّد احتراما وكرامة وتنوعا وحكمة، وتعتمد على فِعْل. لا يوجد أي شيء شبيه أو قريب من هذه العبارة، لا في فنلندا ولا في غيرها من المجتمعات الغربية. لا أرى مبررا لإهمالنا لها والتمسّك بمقياس يمسخ الإنسان إلى رقم سوى تخديرنا عبر رموز توحي بوَهْم إيجابي. لم يرسم السكاكيني صورة محددة في ذهنه، ولا مستوى معين، على كل طفل أن يصلهما بل كان همُّه أن لا يكون الطفل نسخة عن أحد بل صادقا مع نفسه وشديد الانتباه لما يجري حوله ويعمل ما فيه خير لمجتمعه. هذا بالنسبة له جوهر الحكمة والكرامة والتحرر – القيم التي عاش وفقها. كذلك، حاول التخلص من شرذمة الحياة وتجزئة المعرفة. ارتكز في عمله على ما هو متوفر لدى كل شخص ولا يرتبط بأجوبة جاهزة ومعايير عالمية بل بأفعالٍ وسياقات. اهتم السكاكيني بهذه النواحي ب‘الفطرة’ وعبر تأمّلٍ واجتهاد لفهم ذاته والعلاقة بين داخله وخارجه والتعبير عن ذلك بصدق وإخلاص. لا شك أنه احتاج حتى يصل إلى ما توصل إليه إلى أمانة فكرية، مغيبة عادة من المؤسسات. شخصيا أُومِنُ بأن أهم ‘موضوعين معرفيين’ للأطفال هما التربة الأرضية والتربة الثقافية اللتان تغذيانهم. الحكواتيّون الذين يحملون بداخلهم نبض الحياة وروح الحضارة والثقافة والمجتمع وتكون معارفهم ظاهرة في أسلوب حياتهم، ومجبولة بكيانهم، يشكلون أفضل المعلمين ضمن التربة الثقافية. الحكواتي ينقل عبر حكاياته عالما متناغما عن طريق رسم صور عن الواقع والتاريخ والبشر في مخيلات الأطفال. يفعل ذلك عبر بيانٍ حيٍّ حيوي جميل. ما يميّز الحكواتي قراءةُ الحياة. المعلم الملهم ليس من يحمل شهادة بل من يشارك الناس بما تبلور ونضج بداخله وما يجسده في أسلوب حياته. لم يستعمل السكاكيني كلمات لها إيحاءات إيجابية بدون دلالات أو أن دلالاتها تعود إلى ‘الاحتذاء بحذاء الغير’ أو إلى نمط الاستهلاك في العيش، مثل حداثة وتقدُّم وتميّز ونخبة وتفوق والتي تمزق النسيج المجتمعي بل عن كرامة وحكمة وتحرُّر – قيم مغيبة من التعليم الفنلندي. لم يتكلم عن تحسين التعليم وتطوير المناهج، ولا عن التخلص من التقاليد بل جسّد (دون وعي) مبدأ ‘الزباتيين’ (أهالي ولاية ‘تشياباز’ جنوب المكسيك) في حركتهم (1994): ‘تغيير التقاليد بطرق تقليدية’، أي بدون تمزيق المجتمع ومناعته الذاتية. الزباتيون ذاقوا الأمرّين من الأوروبيين؛ هم فلسطينيو المكسيك منذ 500 سنة، لم يفقدوا الأمل ووضوح طريق التحرر. أجدهم أكثر الناس إلهاما حاليا بالنسبة لقضايا كثيرة، خاصة في التعلم والتعليم.
يبرز هنا سؤال: كيف نفسّر الصخب والمديح الكبيرين حول التعليم الفنلندي، وعدم الانتباه لرؤى عديدة حول العالم تشمل كرامة وحكمة وتحرر؟ يكمن السبب برأيي أن أوروبا منذ أكثر من 400 سنة بَنَتْ سيطرتها على ادعاء التفوق الذهني والأخلاقي. وفّرت فنلندا للأوروبيين والأمريكيين (في وقت تتحرر فيه مجتمعات عديدة من هيمنة التعليم الرسمي المركزي) مثالا أبقى المرجعية للتقدم ضمن الفلك الغربي. نجد أنفسنا نقع بالفخ مرة أخرى حيث ندعو للاحتذاء بالتعليم الفنلندي. الأوروبيون وضعوا الفكر فوق الحياة وتعاملوا معها كتطبيق لنظريات ومفاهيم. نحن في وضعٍ أفضل؛ ما زال لدينا فسحة ننطلق من الحياة والحكمة التي تراكمت عبر عصور – تماما كما فعل السكاكيني. العيش وفق الكرامة والحكمة والتحرر لا يظهر في عالم المفاهيم بل في نمط حياة الشخص والمجتمع. فنلندا لم تستطع كما يظهر أن تتحرر من البقاء بين الأغصان إذ استمرت في العمل ضمن أهداف لا ضمن رؤيا. السكاكيني عمل ضمن رؤيا لا ضمن أهداف؛ الرؤيا تنتمي إلى الجذور. معظم الطلبة العرب الذين يذهبون إلى جامعات أوروبية وأمريكية ينبهرون بخبراتهم الأولى والتي عادة تكون أفضل من التعليم الذي مروا به في المدارس. لكن أطلب منهم أن ينظروا في الأمر: التحسين الذي يشعرون به، هل هو على صعيد الأغصان أم في الجذور؟ قوة حضارتنا تكمن في الخلطة. كثير من الممارسات السائدة في مجتمعاتنا ضروري معالجتها، لكن ضروري أن يتم ذلك دون تمزيق النسيج فيها، بل وفق مبدأ الزباتيين الذي ذكرته سابقا.
السكاكيني لم يجسد ما يشار له اليوم ب‘برادايم شفت’ paradigm shift بل تحرير الفكر من مفهوم البرادايم بالذات. ينقلنا إلى عالم نحكم فيه حياتنا. بوصلتنا كما قلت ثلاثية المكونات: حكمة وكرامة وتحرر (ولا أقول حرية). ضروري ذكر أن السكاكيني الذي أتكلم عنه هو الذي عاش قبل الاحتلال الانكليزي، حيث كان فكره مثل نبع صاف من الماء. الاحتلال الانكليزي (رغم مقاومة السكاكيني له) إلا أنه لوّث إدراكه وتعبيره وفكره وحتى عمله. ما لم يتلوث هو صدقه مع ذاته ومع ما يفكر به وما يقوله.
* * *
من الأسباب التي دفعتني أن أكتب ما كتبته بأعلاه هو ما حدثتني عنه ‘دينا بطاينة’ عن صديقة Vanessa قابلَتْها في أحد اللقاءات حول التفكّر ببدائل للتعليم الرسمي السائد بما في ذلك الجامعي. عندما سمِعَت تلك الصديقة التي تعمل بجامعة في كندا عن التعليم بفنلندة قررت أن تأخذ ابنتها (10 سنوات) إلى فنلندا. بعد فترة، قررت العودة إلى كندا. كتبت عن تجربتها بفنلندا. من أغرب ما صادَفَتْه بالنسبة للتعليم هناك ما يمكن أن نشير له ب‘أكل إلزامي’، تماما مثل تعليم إلزامي، حيث ‘خبراء’ يقررون ما يدخل أمعدة وعقول الأطفال! كانت Vanessa مثلا تحضّر الأكل بعناية كبيرة بالنسبة لما تحبّه ابنتها وما هو مغذي وعضوي. تمّ إنذار البنت وأمّها حول إرسال أكل مع ابنتها، وعلى الابنة أن تأكل ما يُقَدّم لها بالمدرسة! الأكل لا يرتبط فقط بتذوّق بل أيضا من أهم ما يجدل نسيجا بين أفراد العائلة، مما يجعل استبدال الأهل بخبراء أكل وفكر عملا خطيرا يغيّب المسؤولية لدى الطلبة والأهالي معا. أنهي هذا المقال بشعرٍ يلخص ما شعَرَت به Vanessa وعَنْوَنَتْهُ ب‘لطف متوحش’ brutal kindness
Brutal kindness
By Vanessa de Oliveira Andreotti
We welcome you to our nation
Our borders open only to a few
We ask for nothing in return, except
That you recognize the deepest wisdom
That when in Rome you should pay tribute to the Romans
Therefore, you must
speak our language
admire our deeds
adopt our dreams
obey our laws
embrace our values
praise our intelligence
like our food
fulfil our expectations
mimic our behaviour
contribute to our economy
aspire to be like us
commit to serving this country
dedicate your life to our people
and be thankful for our efforts to help you
We offer you unlimited hospitality
We chose you amongst countless others
We ask for nothing in return, except
That you acknowledge the natural exceptionality of our people
Expressed precisely in your inclusion in our society
Therefore, you must
know your place
do as you are told
strive for your best
work twice as hard
feel indebted
show good manners
be clean and organized
get an education
dress appropriately, smell nice
pay your duties
lay low, be happy, focus on positive things
use language that we can understand
entertain us with your culture, when requested
and jump off the balcony, if required
We give you access to the best welfare and education system
We expect you to show us that you truly deserved it
We ask you for nothing in return, except
That you appreciate the privilege of being allowed amongst us
Therefore, under no circumstance,
should you break our trust
complain or communicate disapproval
expose our inadequacies, reveal our contradictions
disclose our insecurities, question our values
challenge our authority or understanding of reality
make up unreasonable accusations
fuel internal dissent
defy our right to distinguish our heroes
remind us of what we choose to deny
speak of the past we want to forget
outperform, outsmart , outshine us
or bite the hands that feed you
We will do everything in our power for you to properly fit in
We are certain you will acknowledge our benevolence
We expect nothing in return, except
Your gratitude and compliance
Therefore, you will not mind when we lovingly
limit your autonomy
mute your conscience
undercut your confidence
interrupt your dreams
place your body and mind under surveillance
and shape your subjectivity into conformity
for your own good
We will give you incredible opportunities
in an incomparable country
We ask for nothing in return, except
…that you salute our openness, altruism and sense of justice
[Vanessa de Oliveira Andreotti is Canada Research Chair in Race, Inequalities and Global Change. University of British Columbia, Canada. She was chair of global education from 2010 to 2013; University of Oulu, Finland. The poem appeared in an article in the European Journal of Cultural Studies (2015)]