أستعمل تعبير “الرجل الأبيض” لأنه التعبير الذي استعْمَلَه ضحاياه الأُوَل في القارات الأمريكية منذ 525 سنة. جدير بالذكر أنهم وصَفُوه بصفة لا احتقار فيها (كما تفعل القبيلة الأوروبية) بل بصفة رأوها بعيونهم: لونه أبيض. لا يزال أهالي تلك القارات الأصليين يستعملوا هذا التعبير. أستعمله للتذكير بأن ما فعلته القبيلة الأوروبية في القارات الأمريكية لا تزال تفعله بأماكن عديدة حول العالم بما في ذلك بلادنا. أستعمله لأن معظم ضحايا تلك القبيلة (ونحن منهم) نستعمل صفات ك “حديثة” و”متقدمة” لوصف تلك القبيلة’، صفات توحي بأنها مدنية عالمية. لم تصل مدنية قبل هذه القبيلة إلى ضحالة فكرية حيث تصف نفسها بالحديثة رغم أن كل المدنيات (بما في ذلك العربية الإسلامية) كانت حديثة وقت ظهورها. أخطر ما يهدد الحياة على الأرض هو استمرار “الرجل الأبيض” قابعاً بعقولنا يتحكّم بشتى نواحي حياتنا. انتزاعُه من عقولنا أصبح أمرا ضروريا في صراعنا كبشر من أجل البقاء. صعبٌ جدّا ذكر ناحية في التعليم الرسمي والأكاديمي حول العالم لا نجد “الرجل الأبيض” قابعاً فيها يعيث فساداً وتخريباً. [جدير بالذكر: لا أستعمل تعبير “الرجل الأبيض” من منطلق عنصري؛ زوجتي مثلا منذ 51 سنة من الجنس’ الأبيض.] فيما يلي مثال يوضّح ما أعنيه. في الصف التاسع، احتوى كتاب الرياضيات الآتي لتوه من لندن لمؤلفه “دوريل” على فصل حول الأسهم والسندات. حصلت على علامة كاملة في كل الامتحانات التي أُجْرِيَت في ذلك الفصل. حتى الآن لا أعرف الفرق لأني لم أقتني في حياتي أيا منهم. مثال صارخ حول كيف أنني لم أكن من يجيب على الأسئلة بل الرجل القابع في عقلي. مدحوني فأعموني. من بين المسائل التي كان عليّ أن أحلّها:
(1) A man invests 450 pounds in Indian 2% stock at 69. Find, to the nearest penny, how much stock he buys and the income from it. (2) London Brick 8% (1 pound) shares stand at 36s., and Rio Tinto 5% shares stand at 4. Which investment gives the larger yield?”
هناك توضيحٌ آخر أرى ضروري ذكره: أبدعت القبيلة الأورو-أمريكية باختراع أجهزة وأدوات. يجب أن لا نقع بوَهْم التقدم على صعيد أجهزة بأنه يعكس تقدمًا في جوهر الحياة، إذ من الصعب ذكر ناحية في الجوهر تحسنت منذ استلام القبيلة الأوروبية دفّة القيادة. ما نعيشه من أزمات وأخطار عالميا، هو نتيجة وَضْعِ العقلَ على العرش وسجن الحكمة. العقل قوة هائلة في الإنسان لكن دون حكمة نكون كقارب وسط أمواج هائجة دون بوصلة. بوصلة البشر الحكمة. البوصلة المهيمنة الآن هي نمط الاستهلاك في العيش؛ نمط همُّه الأكبر الإسهام في تراكم رأس المال أسّيّا. يجب التمييز بين معارف تقنية ومعارف حياتية ترتبط بالعيش بحكمة. استعادة الحكمة تشكّل التحدي الجوهري الذي نواجهه حاليا. أعود لأؤكد أن العقل دون حكمة طاقة تستطيع فعل الكثير، لكن العقل يرى الإنجازات لا عواقب ما نقوله ونفكر به ونفعله. دون حكمة، لا أمل لاستمرار الحياة على الأرض.
ما يدعو للأمل حالياً ظهور حركات وتجمعات حول العالم، متزايدة باستمرار، تعمل على انتزاع الرجل الأبيض من عقولها وانتزاع نفسها من العبودية الفكرية المعرفية له. ربما تكون حركة “الزباتيين” بجنوب المكسيك أكثر الحركات إلهاما في هذا. أول فلسطيني قاوم دخول “الرجل الأبيض” إلى عقله كان خليل السكاكيني (خاصة في النصف الأول من عمره). كتب (عام 1896 وهو بعمر 18 سنة) كتابه الأول “الاحتذاء بحذاء الغير”، و”الغير” الذي عناه في رأيي هو الرجل الأبيض الذي تمثَّلَ بالمدارس الأوروبية والأمريكية التي كانت بمنطقة القدس. جسّد السكاكيني قناعاته بعد 13 سنة في أول مدرسة أنشأها عام 1909 حيث رفع شعار “إعزاز التلميذ لا إذلاله” وترجم ذلك عملياً بلا علامات ولا جوائز ولا عقاب فيها. لكن رغم بروز حركات وتجمعات تعمل حول العالم على التخلص من هيمنة التعليم الرسمي والأكاديمي وتصفه بالكولونيالي، لا يزال الضعف الأعمق والخطر الأكبر في رأيي يكمن في أن معظم الحركات الثورية الساعية للتغيير تقاوم على أصعدة شتى، لكنها تُبْقي الرجل الأبيض قابعا ينهش في المناعة الذاتية لدى الإنسان والمجتمع والطبيعة مما يجعلنا عرضة سهلة لأمراض وأوهام ينشرها “الرجل الأبيض” (عبرنا حاليا) والتي تشكّل سببا رئيسيا للتخريب والأزمات التي نعيشها في العصر الحاضر.
كان “نجاحي الباهر”، خلال السنوات الثلاثين الأولى من عمري، خاصة بالرياضيات، مكافئا لحجم “الرجل الأبيض” الضخم الذي كان قابعا في عقلي. (انظر المثال بأعلاه). لكن أعتبر نفسي محظوظا لأن ما احتجتُه لإخراجه من عقلي كان متوفرا لديّ: عشت معظم حياتي بفلسطين (التي لا تهدأ ولا تسمح للتخدير أن يترسّخ فينا)؛ وعشت دون دولة قومية (التي وصفها الشاعر الباكستاني “محمد إقبال” عام 1935 هي والبنوك بأفيون الشعوب). كما كنت محظوظا إذ عشت إلى جانب أمي الأمية التي كان عالمها أصيلا يستمد كلماته ومعانيه ومعرفته من الحياة والفعل والتأمل والاجتهاد. هذه الأمور ساعدتني بالتدريج عبر سنين في الشفاء من أمراض “الرجل الأبيض” على صعيد المعنى والفكر والتعبير والفِعْل والعلاقات (ووضعت “الرجل الأبيض” ضمن حجمه الحقيقي المتمثِّل بمعارف واختراعات تقنية). أما الناحية الرابعة التي كنت فيها محظوظا فهي أني عشت معظم حياتي قبل أن يُسْمَحَ لجرثومة “التنمية” (كما حددها “ترومان”) بدخول البلد، إذ تطلبت وجود “دولة قومية”، والذي حصل عام 93-1994.
أول حدث بدأ بخلخلة المقعد الذي كان يجلس عليه “الرجل الأبيض” في عقلي هو حرب 1967. كنت وقتها حاصلا على ماجستير أدرّس الرياضيات بكلية بيرزيت، كما كان زملائي أيضا حاصلين على شهادات عالية. نبهتني تلك الحرب إلى أن المعارف والشهادات التي اكتسبناها لا علاقة لها بما يحدث حولنا. لم نعرف لماذا حدث ما حدث ولماذا لم يحدث ما لم يحدث. لم تكن معارفنا مرتبطة بالحياة (سوى علاقتها بعالم الاستهلاك). أعيد: كانت تلك الحرب أول حدث خلخل الكرسي الذي كان يجلس عليه “الرجل الأبيض” في عقلي؛ خلخله لكن لم يخرجه كليا من عقلي. انتظرتُ 9 سنوات أخرى قبل الحدث الذي زلزل وهشّم الكرسي في عقلي مما جعل جلوس “الرجل الأبيض” عليه بأمان مستحيلا. بدأ شفائي على صعيد الجذور بوعيي أن الرياضيات التي كانت تمارسها والدتي الأمية تنتمي إلى عالم مغيّب وخفي، عالم ليس له وجود أو شرعية بالجامعات والكتب المقررة والأكاديمية ولا في أي مؤتمر حول الرياضيات. وعيت عام 1976 أن الرياضيات التي كانت تمارسها لا أستطيع فهمها ولا عمل مثلها مهما درست بجامعات حتى لو كان ذلك على أيدي رياضيين عظماء! لا يمكن وضع معرفتها ضمن نظريات ومصطلحات أكاديمية. كانت تتعامل مع أصعب أنواع الهندسة: أجسام النساء! ادعى “ديكارت” أن هناك أبعادا ثلاثة نستطيع عبرها تحديد كل نقطة والتحكّم فيها. لو ذكرتُ ذلك لأمي لربما شَعَرَتْ بشفقة عليه إذ لم يكن لهندسته موقع في فكرها وعملها. في حياكة ملابس كانت تتعامل مع عشرات الأبعاد. فَقَدَ ديكارت مقعده بعقلي وأصبح “صايع” يمشي على غير هدى. كذلك مع “برتراند راسل” (من أهم الرياضيين والمنطقيين في القرن العشرين، وكان أكثر شخص أحببته وقرأت له بالمدرسة والجامعة)، فرغم غزارة معرفته ومواقفه المشرِّفة في أمور السياسة والمجتمع، لم ينتبه لدور الرياضيات في التخريب الذي نشهده عالميا على أصعدة شتى، ولم ينتبه للرياضيات المعقدة التي يمارسها كثيرون كأمي دون دراسة وشهادات (ربما لأن المرأة التي ربّته كانت “كونتيسة” تتصرف في حياتها اليومية وفق لَقَبِها، بينما أمي كانت تعيش وفق قلبها وأصابعها سرّ معرفتها وفهمها). بقي ل “برتراند” مكان في عقلي لكن بلا كرسي، واتخذ حجمَه الحقيقي: بارع بالتعامل مع رموز وعلاقات ذهنية وأنظمة منطقية.
عام 1949، جاءنا “الرجل الأبيض” بلباس جديد اسمه “التنمية” والتي مثّلت نسخة طبق الأصل عن التعليم الرسمي الذي صممه نبريها قبل 500 سنة. لم نسمع كلمة تنمية في بداية الخمسينيات بل بتعبيرٍ غريب “النقطة الرابعة” والتي سمعناها تتردد عشرات المرات دون أن نفهم لماذا سًمِّيت بهذا الاسم. وعيت فقط بعد سنوات عديدة أن التعبير يشير إلى التنمية التي كانت النقطة الرابعة في خطاب ترومان عام 1949 والتي كانت في جوهرها طبق الأصل لفكرة التعليم الرسمي من حيث إقناعنا بأننا متخلفون وأن أمريكا وغرب أوروبا على استعداد لمساعدتنا في النمو وفق طريقهم! ارتبطت جرثومة التنمية بجرثومة “التقدم” التي أقنعونا عبرها أننا متخلفين وأن مسارهم هو مسار التقدم وأنهم لطيبة قلوبهم على استعداد لمساعدتنا للسير على طريقهم ونصبح مثلهم !
إذا صبّينا جرّة ماء نقي في بركة ملوثه فإن الماء النقي سيتلوث وليس العكس. إذا قمنا بتحسينات عديدة جميلة نظيفة فنية أدبية ثقافية تراثية تربوية لكن بقي الرجل الأبيض (كأيديولوجية وفكر ومصطلحات وقِيَم وتقييم) قابعا في عقولنا فإن كل ما نفعله من تحسينات على أصعدة أخرى سَيُلَوَّث. شفاؤنا من الأيديولوجية البيضاء على صعيد الفكر هو أساس تحرّرنا من الإخطبوط الذهني الأبيض. كيف يمكن أن يتم هذا؟ لحسن الحظ، معظم ما نحتاجه كمقومات متوفر لدينا كبشر وحضارة. تشمل المقومات البشرية القدرات البيولوجية بما في ذلك التعلم والشراكة في تكوين معنى وفهم (مما يعني تجنب استهلاك معانٍ جاهزة صادرة عن مؤسسات وخبراء القبيلة الأورو-أمريكية)، والنطق والإصغاء، وروح الضيافة، وروح الحكمة التي انطلقت في منطقتنا من مصر وإفريقيا وبلاد الشام وبلاد الرافدين وبلاد فارس والهند والسند واليونان. هناك أقوال عديدة لأنبياء وفلاسفة وحكماء وأئمة كما أن هناك أمثالا كوّنها أهالي هذه المناطق من تفاعلهم مع الحياة. كتبت في مقالات عديدة كلمات بالانكليزية التي تتوافق مع العلم كأداة لإخضاع الطبيعة والبشر، ورديفاتها المستعملة بالعربية التي تتوافق مع العلم كفهم الطبيعة لحمايتها وحماية البشر.
ًما قلته بأعلاه ينتمي إلى الجذور إذ يشكّل أساس حماية مناعتنا الذاتية على شتى الأصعدة. أي إضافة لا تسلبنا مناعتنا أهلا وسهلاً بها. لكن إذا أدت إلى ضعف المناعة، على أي صعيد، من الأفضل تجنبها – مهما كانت المكاسب على صعيد الأغصان.



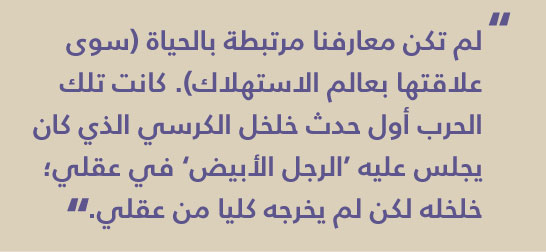
“أحب الأطفال.. و لدي همّ تطويرهم و الحفاظ على شخصياتهم و على نفسياتهم.. إلى حد كبــير”\r\nشدتني هذه الجملة